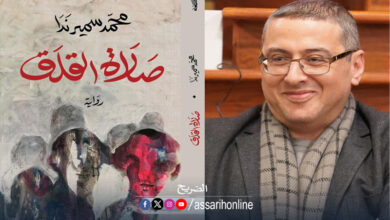نوفل سلامة يكتب: التخلف الآخر ومفهوم علم الاجتماع الطارد


كتب: نوفل سلامة
نشر الدكتور محمود الذوادي أستاذ علم الاجتماع في مجلة ‘الكلمة’ الفصلية الصادرة عن منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث بلبنان ضمن عددها 125 خريف 2024 دراسة تعرض فيها إلى مصطلح جديد ومفهوم غير متداول في العلوم الاجتماعية يعرف بـ ‘علم الاجتماع الطارد’…
هذا المفهوم الجديد يقول الدكتور الذوادي أنه لم يسبقه إليه أحد ولم يُستعمل من قبل من طرف علماء الاجتماع وكل الباحثين في الظواهر التي تناولت دراسة المجتمعات، ليقدم مبحثا جديدا في علم الاجتماع يهتم بدراسة الظواهر والمعالم البشرية لدى الأفراد والمجتمعات من خلال عناصرها غير المادية..
الظواهر غير المادية
ذلك أن علم الاجتماع التقليدي ليس من مجالاته تفسير والاهتمام بالظواهر غير المادية كموضوع الثقافة وكل الرموز والظواهر الثقافية، في مقابل مفهوم آخر يعرف بعلم الاجتماع الحاضن للظواهر المادية وغير المادية على السواء كمؤثرات في فهم سلوكيات الأفراد و حركية المجتمعات البشرية..وعلى هذا فهو يرفض اقصاء دراسة الظواهر الثقافية باعتبارها مجموعة من الرموز مثل اللغة والفكر والدين والمعرفة والعلم والأساطير والقوانين والقيم والأعراف الثقافية لها دورها وقيمتها في فهم وتحليل طبيعة المجتمعات وسلوك الأفراد.
مركبات النقص
صفة الطرد هذه التي نجدها في علم الاجتماع الغربي تشمل ما يسميه الدكتور الذوادي بظاهرة ‘التخلف الآخر’ التي تعرفها مجتمعات العالم الثالث المتمثلة في شعور شعوب عالم الجنوب بمركبات النقص إزاء الغرب، من صورها استعمال اللغات الأجنبية عوضا عن اللغات الوطنية المحلية والتبعية للعلوم والثقافة الغربية وهيمنة انتشار القيم الثقافية لمجتمعات العالم الغربي..
ويمكن تفسير عدم اهتمام علماء الاجتماع الغربيين بظاهرة شعور بعض المجتمعات بالنقص تجاه الآخر المتفوق إلى كون الباحث في علم الاجتماع من الغربيين عادة ما يتأثر بقيمه وأفكاره، وهي قيّم تعبر عن التفوق والريادة وهي متحيزة وتمثل مجتمعاتهم، لذلك نجد قناعة تحكم هذا المجال في تفسير ظاهرتي التنمية والتحديث التي عادة ما يتم ربطها بالموروث الثقافي من قيم وعادات وتقاليد ودين هي حسب بعض علماء الاجتماع من يمنع أو يعرقل عمليات التنمية والتحديث.
معالم ضرورية
قيمة الملاحظة التي أشار إليها محمود الذوادي في ضرورة إبراز أهمية العناصر غير المادية في إعطاء قيمة للمجتمعات البشرية وتميزها وفرادتها في الحديث عن معالم متعالية للثقافة المحلية في إعطاء هوية للإنسان وتحديد جوهره، وهي عناصر عادة ما تكون غير مادية فيها الجانب الروحي كالدين وتعلم القراءة والغوص في العلم وكسب رهان التفكير والاتصاف بالقيم النبيلة وحسن الخلق وهي معالم ضرورية ومحددة للحفاظ وتخليد التراث الجماعي للمجموعات البشرية وتسجيل ذاكرتها.
طاقات كبيرة
يؤكد الدكتور الذوادي على قيمة الرموز الثقافية في كونها تمنح الأفراد طاقات كبيرة وقوة لمواجهة التحديات بكل أصنافها ومن دون ثقافة بمفهومها الواسع العناصر المادية وغير المادية لا يمكن مجابهة الصعاب فمن خلالها يتم شحذ همم الافراد وهي تشبه إلى حد كبير القوى المتعالية الماورائية فمصدر إرادة الشعوب الحقيقي يكمن في عالم الرموز الثقافية وهذا يحيل الحديث على معجزات الشعوب في صراعها مع القوى المعادية لها بالرغم من عدم توفر المعطيات المادية للنصر ومثال ذلك عملية طوفان الأقصى وما حصل في حرب غزة مع الكيان الصهيوني.
التخلف الآخر
يعتبر صاحب الدراسة أن عدم الاهتمام بمسألة التخلف الآخر يعبر عن تحيز معرفي وعلمي للغرب وعدم موضوعيته وهي مسألة يراها ماكس فيبر طبيعية ولا تمثل إشكالا لطبيعة العلوم الاجتماعية والإنسانية والانتماء الباحثين في هذه الظواهر إلى مدارس ومذاهب ونظريات مختلفة فالماركسية مثلا ليست هي نفسها المدرسة السلوكية وهما مدرستان تطردان وتهمشان من حساباتهما العوامل الأخرى في سلوك الفرد والجماعات.
من العوامل الأخرى التي تجعل علم الاجتماع الغربي متحيز وغير موضوعي ما نلحظه من طغيان الأيديولوجيا على حساب الدراسة الموضوعية وانتماء المختصين فيه إلى تيارات فكرية وايديولوجية معينة من ماركسية وغيرها وهذا ما جعل من مسألة الموضوعية إشكالية في علوم المجتمع والانسان فعالم الاجتماع هابرماس يعتبر أن المعرفة على العموم والمعرفة الاجتماعية على الخصوص تعكسان مصالح واهتمامات المفكرين والعلماء والباحثين لذلك كانت الموضوعية في مجال علم الاجتماع مسألة مستعصية…
ولكن هذا لم يمنع من توجيه النقد إلى مباحث وموضوعات علم الاجتماعية ومناهجه من حيث منطقية الفروض النظرية التي يقوم عليها والمفاهيم المستعملة وانعكاساتها ومطابقتها مع معطيات الملاحظة والمشاهدة ما يطرح سؤال المصداقية أو يضعف من معناها خاصة فيما تقوم به من تعميم نتائجها ومفاهيمها على كل المجتمعات ومن حضارة إلى أخرى و تطبيق نظريات علم الاجتماع على كل الأقوام رغم الاختلاف في التكوين و السيرورة التاريخية والبنى الاجتماعية فمفاهيم التنمية والتحديث وكل النظريات الملتصقة بهما يفصحان عند دراسة المجتمعات الشرقية على تحيز وعدم موضوعية من ذلك قولهم أن المجتمعات الشرقية لا يمكن لها أن تحقق مشاريع التحديث أو تنجز نهضة حضارية إلا إذا تبنت النموذج الغربي للتحديث وبالتالي فإن النموذج الغربي للتحديث هو صالح للتطبيق على مستوى عالمي من دون مراعاة للخصوصيات الثقافية والاختلاف القيمي وبذلك يكون علم الاجتماع المعاصر قد طرد وألغى من مجال بحثه أي دور لخصوصيات المجتمعات والحضارات بالنسبة لعملية التحديث وبهذا الموقف فقد خلصوا إلى أن عملية التحديث مرتبطة أساسا بالصناعة والتنمية الصناعية وطالما وأن الكثير من المجتمعات لم تدخل عالم التصنيع فهي مجتمعات متخلفة.
مأزق العلوم الاجتماعية
مأزق العلوم الاجتماعية والإنسانية المعاصرة في علاقتها بإشكالية مفهوم الموضوعية والتحيز والتحديث أنها لم تقبل فكرة أنه لا توجد نظريات علمية لفهم التغيير الاجتماعي والتنمية إلا في إطار بيئة معينة ومجتمع محدد ذي خصائص مميزة فـ مصداقية النظرية مرتبطة بالظاهرة المدروسة.
لقد كان ابن خلدون سابقا غيره من دارسي المجتمعات والسلوك البشري في الاعتناء بالظواهر غير المادية في المجتمع الإنساني وجعل منها أدوات تفسير وفهم كالسحر والدين وكل الغيبيات في سياق غير مألوف في علم الاجتماع التقليدي رغم أن جانبا من دارسي الفكر الخلدوني يعتبرها تعبر على الجانب اللاعقلاني في كتاب المقدمة وهي عندهم جزء من البحوث الاستطرادية غير الأصلية التي نجدها في الكتاب وعودة الدكتور محمود الذوادي إلى ابن خلدون فيها موقف واضح من كل المختصين في مجال علم الاجتماع الطارد للعناصر اللامادية التي تشكل صورة وحياة المجتمعات والتي يتم في الكثير من الأحيان اهمالها وبالتالي تقديم فهم ناقص أو مشوه عن تلك المجتمعات وهو بهذه الرؤية يعلن انتمائه إلى فئة علماء الاجتماع الحاضنين لمختلف الظواهر الإنسانية في توجه جديد ظهر ضمن مفهوم ما بعد الحداثة أو ضمن التيار المناهض للهيمنة الغربية للمعرفة أو إلى حركة الديكولونيالية التي ظهرت في أمريكا اللاتينية، والتي بدأت تكتسح المعرفة والفكر والجامعات حول العالم فـ مفهوم علم الاجتماع الحاضن يختلف عن علم الاجتماع المعاصر في كونه يفسر نهوض وسقوط الدول بعدة عناصر لا بعنصر واحد كما تفعل مدارس علم الاجتماع التقليدية..
وهذا ما يميز ابن خلدون منذ قرون وسبق علمه للعمران البشري باقي العلوم الأخرى في مجاله في إبرازه لمبدأ تعدد المؤثرات مكان مبدأ أحادية المؤثرات في فهم وتفسير حركة المجتمعات وظواهر السلوك البشري نظرا لكونها ظواهر معقدة لا يمكن أن تفسر أو تفهم بعامل واحد كما فعلت الماركسية أو المدرسة السلوكية.
المنحى العقلي
لقد ظلت النظرة النقدية عربا ومستشرقين ترى في المقدمة السادسة من كتاب المقدمة معارضة للعقل وخارجة عن موضوعية علم الاجتماع، كما تأسس حديثا إلى أن جاء المفكر محمد عابد الجابري ودافع عن ابن خلدون ورد أقوالهم و تبعه في ذلك الدكتور الذوادي الذي أيد الجابري فيما ذهب إليه من كون ابن خلدون لم يناقض العلم ولا الروح العلمية ولا العقلانية حينما أحضر العناصر الغيبية في فهم الحضارات ومراحل تأسيسها وأفولها واعتبر أن فهم السلوك البشري وحركة المجتمعات بعوامل غيبية وعناصر غير مادية لا يضر في شيء المنحى العقلي في دراسة الظواهر ولا ينزع عن صاحبها الصفة العقلية.
العودة إلى ابن خلدون
قيمة العودة إلى ابن خلدون فيما لفت إليه النظر في مقدمته إلى مسألة في غاية من الأهمية حول موضوع فرادة العلوم واستقلاليتها عن غيرها وأهمية فك الارتباط عن الآخر في المجال المعرفي فيذهب إلى أن العلوم التي وصلت إلى العرب والمسلمين هي علوم أمة واحدة وحضارة واحدة وهم اليونان خاصة وكان ذلك بفضل ما قام به الخليفة العباسي المأمون من ترجمة لها وإخراجها من لغتهم باقتدار في عملية نقل فريدة وأمينة صرفت فيها الكثير من الأموال والحال أن ما نقل عن اليونان هو معارف وعلوم سابقة تراكمت من علوم نقلت عن أمم وأقوام أخرى لم يذكرها اليونان ونسبوها إليهم كعلوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وعلوم الاقباط والفراعنة ويؤكد أن علم العمران البشري الذي توصل إليه هو علم جديد ليس نتيجة تراكمات علمية سابقة وإنما هو علم مستقل بنفسه.