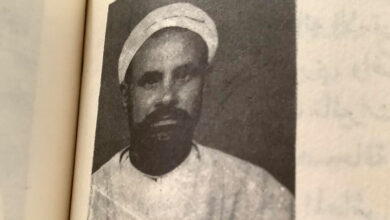نوفل سلامة يكتب/ المناولة من شركات إسداء خدمات إلى مكاتب توظيف: ثقافة التحايل على القانون لإذلال البشر


كتب: نوفل سلامة
المناولة هي مصطلح ومفهوم ظهر لأول مرة في تونس، وتم تبنيها من قبل المشرّع وتعرّف عليها المجتمع في بداية التسعينات من القرن الماضي، حينما فكرت بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص وتبعتها في ذلك مؤسسات القطاع العام التابعة للدولة في طريقة للتقليل من أعبائها المالية..
وخصوصا التحكم في كتلة الأجور التي بدأت تشكل عبـئا عليها، وذلك بالتقليل من الموظفين الذين يُمكن التخلي عنهم والاستغناء عن أعمالهم من خلال فكرة فسح المجال أمام الإدارات الحكومية على غرار البلديات والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير، وغيرها من مؤسسات الدولة وكذلك المؤسسات البنكية ومؤسسات القطاع الخاص للتخلي عن جزء من أعمالها ومهامها التي كانت تقوم بها، والتي لا تدخل ضمن أنشطتها الأصلية ومنحها إلى شركات خاصة تتولى إسداء وتقديم هذه الخدمات بدلا منها…
4 اختصاصات
فكان الأمر عدد 49 المؤرخ في 16 جانفي 1996، وهو النص القانوني الذي أقر آلية المناولة وسمح لمؤسسات تابعة لبعض الخواص بتقديم خدمات وأعمال لفائدة هذه المؤسسات، وحصر هذه المهام في أربعة اختصاصات وهي الحراسة والتنظيف والتكوين والرسكلة، غير أن هذا النص الذي نظم مجال نشاط المناولة قد فتح الباب ووسّع من نشاط هذه الشركات ومكنها من تجاوز حدود ونطاق تحركها من خلال وضعه لعبارة فضفاضة قابلة للتأويل ومانعة من الحصر حيث خوّل لشركات المناولة تقديم خدمات أخرى تحت عنوان ‘كل نشاط آخر’ فهذه العبارة التي جاءت في نص الأمر قد فتحت المجال واسعا لتزايد عدد الشركات المتخصصة في المناولة وشركات إسداء خدمات لا علاقة لها بنشاطها الأصلي…
فبعد أن كان نشاط شركات المناولة توفير يد عاملة في مجال الحراسة وأعمال النظافة و الرسكلة والتكوين وهو التوظيف الذي تخلت عنه المؤسسات الخاصة والعامة والمجالات التي قصدها المشرّع عند وضعه هذا القانون، أصبح مجال تدخلها توفير عمال في كل المجالات من عمال حضائر وموظفين وقتيين في القطاع العام والخاص بعقود وقتية تنتهي بانتهاء مدتها ليجد العامل بعد ذلك نفسه دون عمل بعد إنهاء تعاقده وبأجر هو نصف ما تتحصل عليه هذه الشركات من الجهات المستفيدة..
وشيئا فشيئا بدأت شركات المناولة تتكاثر وينمو عددها ويتوسع نطاق تدخلها، ومعها ارتفع عدد العاملين والموظفين وفق آلية المناولة تحت حالة العجز الاجتماعي وبدافع الحاجة إلى عمل حتى وإن كان المرتب والأجر لا يضاهي ما يقدمونه من عمل ولا يلبي حاجياتهم حيث تُشير بعض الأرقام إلى أنّ القطاع العام يشغّل بمفرده نحو 50 ألفا بين عمال وموظفين في أشكال مختلفة في إطار عقود مناولة والعدد يتزايد في القطاع الخاص.
ثم تعمّقت المأساة..
وتعمقت المأساة وصور الظلم بعد أن دخل إلى هذا الفضاء حاملو الشهادات العليا وخريجو الجامعات الذين اضطرتهم الحاجة وندرة العمل وتراجع فرص التوظيف الى القبول بعقود عمل لا تتماشى مع مؤهلاتهم واختصاصاتهم وشهائدهم العلمية، ومن هنا بدأ التلاعب والتحايل على القانون في توافق مفضوح بين شركات المناولة ومختلف شركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة حيث يتم انتداب خريجي الجامعات على أنهم أعوان حراسة وعمّال نظافة في حين يقبل بهم في الجهات المستفيدة موظفين في الإدارة وتمنح لهم مكاتب وأعمال إدارية شأنهم شأن الموظفين المرسمين…
هذه الوضعية الشغلية التي تواصلت لقرابة الثلاثين عاما وكانت في البداية فكرة مستساغة ومقبولة غير أنه لا يمكن أن نواصل معها بعد أن حادت هذه الشركات عن مهامها الأصلية، ووسعّت نطاق نشاطها وتحولت من شركات لإسداء خدمات في مجالات محددة مثل الحراسة والنظافة والتكوين بتوفير عملة للحراسة وعاملات تنظيف إلى مكاتب وهياكل تعنى بالتوظيف والتشغيل غير القانوني تلجأ إليها الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية للحصول على موظفين تحتاجهم في اختصاصات معينة خارج الحراسة والتنظيف، فيتم توفير اليد العاملة المطلوبة ولكن تحت مسمى عقود حراسة ونظافة في تحايل صارخ على القانون وفي عملية تحايل مقنعة وتلاعب خطيرة للهروب من الانتدابات الرسمية التي تحمل المؤسسة المستفيدة أعباء مالية والتزامات قانونية يفرضها قانون الشغل وتوجبها المعاهدات الدولية في مجال العمل…
هشاشة اجتماعية
هذه الطريقة في التوظيف وهذه الآلية في التشغيل قد أنتجت في التطبيق تزايد واقع الهشاشة الاجتماعية في صفوف الشباب، وخاصة شباب الأحياء الفقيرة وأبناء الجهات الداخلية المحرومة بما تقوم به شركات المناولة من فرض واقع غير إنساني وغير لائق وعلاقات شغلية مهينة غير شرعية لا يمكن القبول بها فضلا عن تقنينها وتبنيها في عملية لاستعادة نظام العبودية وصور الرق القديمة وامتهان البشر واستغلال عجزهم وحاجتهم للعمل لتحسين وضعهم العائلي والشخصي في توظيف غير دائم، بعقود مؤقتة في الزمن بعقود مغشوشة ومتحيلة شاركت فيها هذه الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة المستفيدة.
سؤال؟
إذ كيف تقبل إدارات ووزارات ومؤسسات تابعة للدولة بهذا النوع من التشغيل الهش؟ وكيف تقبل بعقود عمل لمواطنين يعيشون حالة من العجز المادي وواقع الخصاصة و لا يتحصلون من وراء آلية المناولة على أجر عادل ومساو لنفس كمية العمل الذي يقدمها الموظف المرّسم في نفس المؤسسة المنتدِبة؟
السؤال المحير في هذا الموضوع هو إذا كان القطاع الخاص الذي يبحث عن الربح المادي بأقل التكاليف ولا يفكر إلا في مصلحته الخاصة وتناسبه ثقافة المناولة ولا يعنيه في شيء قيمة العامل وانسانيته، فكيف قبلت الدولة في فترة من تاريخها بمؤسساتها وهياكلها ووزاراتها بمثل هذه الصيغ في التشغيل؟ وكيف رضيت بمثل هذه الطرق في العمل؟ وكيف قبلت بتشغيل أفراد عندها لا يتقاضون الأجر الحقيقي الذي منحته هي نفسها للشركة التي جلبت هؤلاء الموظفين؟
إن المهم في هذا الإجراء الأخير الذي اتخذته الدولة التونسية ومشروع القانون الذي هو اليوم تحت أنظار نواب الشعب للمصادقة عليه والقاضي بإنهاء العمل بالمناولة كآلية للتشغيل وتجريمها باستثناء بعض الأعمال المضبوطة حصريا، أنها كشفت عن خطورة الثقافة التي كانت سائدة في مجتمعنا وعن الذهنية التي تتحكم في البعض منا وهي مواصلة لنفس فكر وثقافة العبودية ومنظومة الرق التي الغتها تونس منذ سنة 1846 حينما أصدر الباي أحمد باشا قرارا ألغى به الرق وبذلك كان سابقا غيره في إعلاء قيم المساواة والعدل والكرامة بين البشر.